لقد غادرت منزلي في رواندا، البلد الذي ولدت فيه، قبل ثلاثين عاماً عندما كنت في الثانية عشرة من عمري ــ فررت مع عائلتي من أهوال الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994.
نشأت في كينيا والنرويج ثم استقريت في لندن، وكثيرًا ما تساءلت كيف سيكون الأمر عندما أعود وأرى ما إذا كان البلد والشعب قد تعافوا وكيف.
عندما أتيحت لي الفرصة للسفر إلى هناك لإعداد فيلم وثائقي حول هذا الموضوع بالذات، كنت متحمسًا ولكن أيضًا قلقًا للغاية بشأن ما سأجده – وكيف سأتصرف.
تحذير: قد يجد بعض الأشخاص تفاصيل في هذه القصة مؤلمة.
لقد عشت مع الندوب العاطفية لهذه الأحداث على شكل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والذي يمكن أن يحدث بشكل غير متوقع.
مثل العديد من الروانديين، فقدت العديد من أفراد عائلتي. وفي غضون 100 يوم فقط، قُتل 800 ألف شخص على أيدي متطرفين من عرقية الهوتو، استهدفوا أفراداً من أقلية التوتسي، فضلاً عن خصومهم السياسيين، بغض النظر عن أصلهم العرقي.
كما زُعم أن قوات التوتسي التي استولت على السلطة في أعقاب الإبادة الجماعية قتلت الآلاف من الهوتو في رواندا انتقاما.
كانت المشاعر تدور في داخلي عندما هبطت في العاصمة كيغالي.
فرحة سماع لغتي الكينيارواندا يتم التحدث بها في كل مكان حولي. ولكن أيضًا الاعتراف بأن آخر مرة كنت فيها في المدينة، سادت الفوضى، حيث فر الملايين منا للنجاة بحياتهم، محاولين البقاء على قيد الحياة.
بعض الأماكن التي كنت أتوق إلى رؤيتها خلال رحلتي القصيرة كانت مدرستي الابتدائية وبيتي الأخير في كيغالي – حيث كنت أجلس على مائدة العشاء مع أقاربي في تلك الليلة المشؤومة في 6 أبريل/نيسان 1994. وذلك عندما سمعنا أن لقد أسقطت طائرة الرئيس – مكالمة هاتفية قلبت حياتنا كلها رأسا على عقب.
ولكن من بين كل ما يقلقني، لا شيء يمكن أن يتغلب على الحزن الشديد الذي غمرني عندما لم أتمكن من العثور على منزل عائلتي السابق. وبعد أربع محاولات، استسلمت واتصلت بأمي في النرويج حتى تتمكن من إرشادي.
أخيرًا، وقفت أمام البوابة المغلقة، اختنقت عندما تذكرت فترات ما بعد الظهيرة المشمسة الدافئة التي جلسنا فيها على الشرفة نتحدث ونشعر براحة البال.
كما أعاد ذلك بقوة الاضطراب الذي حدث أثناء مغادرتنا – حيث طُلب منا بهدوء أن نرتدي ثلاث مجموعات من الملابس ونحزمها في السيارة في رحلة لم يكن من الممكن أن يتخيلها أحد منا.
لا أتذكر أن أيًا منا تحدث أو اشتكى، على الرغم من أننا أطفال محشورون معًا في الخلف – وحتى عندما يضربنا الجوع بشكل لم أعرفه من قبل.
وفي اليوم السادس، أدركنا أنه لم يعد هناك مكان آمن في كيغالي، لذا انضممنا إلى النزوح الجماعي – محاولين أن نكون غير مزعجين قدر الإمكان عند حواجز الطرق التي يحرسها رجال الميليشيات الذين يحملون المناجل. بدا الأمر وكأن كيغالي بأكملها، الآلاف منا – سيرًا على الأقدام وعلى الدراجات والسيارات والشاحنات – كانوا يغادرون في نفس الوقت.
كنا متجهين إلى منزل عائلتنا في جيسيني، وهي منطقة قريبة من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تُعرف الآن باسم منطقة روبافو.
هذه المرة، عندما قمت بالرحلة، متتبعًا طريقنا إلى بر الأمان، تدفقت حركة المرور بسلاسة ولم تكن هناك طلقات نارية أو طرق مصطفة على جانبيها أشخاص يفرون. هذه المرة كان يومًا هادئًا ومشمسًا وجميلًا.
وجدت منزلنا المكون من ثلاث غرف نوم، والذي كان يأوي حوالي 40 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة من الإبادة الجماعية، لا يزال قائمًا – على الرغم من أنه كان فارغًا منذ أن غادرناه في يوليو 1994.
وكنت محظوظًا بما فيه الكفاية للقاء بعض الأقارب الذين نجوا، بما في ذلك ابن عمي أوغسطين، الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات عندما رأيته آخر مرة في جيسيني.
كان احتضانه بمثابة حلم – أولئك الذين تستيقظ منهم مبتسمين، قلبك ممتلئ. ذكرياتي المفضلة عنه هي أننا كنا نركض في حقول الخضروات القريبة، ونستمتع بما بدا لنا وكأنه امتداد لعطلة عيد الفصح – غير مدركين للخطر القادم.
وهو الآن أب لأربعة أطفال – لكننا تابعنا من حيث توقفنا، ونلحق برحلاتنا منذ أن انفصلنا بعد فرارنا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي كانت تسمى آنذاك زائير.
“هربت وحدي دون والدي وذهبت عبر الريف، بينما مر والداي عبر بلدة جيسيني إلى غوما [the city over the border in DR Congo]،” هو قال.
لا أستطيع أن أتخيل كيف كان الأمر بالنسبة له، وهو صبي صغير وحيدًا بدون والديه في ما أصبح مخيم كيبومبا الضخم للاجئين. على الأقل كانت عائلتي معي عندما هربت.
ولحسن الحظ، فإن بعض الجيران السابقين الذين كان معهم أخبروا والديه في النهاية – قبل ظهور الهواتف المحمولة – وبقيوا جميعًا في كيبومبا لمدة عامين.
قال لي: “في الأيام الأولى، كانت الحياة هناك سيئة للغاية. كان هناك تفشي للكوليرا ومرض الناس، ومات الآلاف بسبب المرض بسبب سوء النظافة ونقص النظام الغذائي المناسب”.
قصته تعكس قصتي إلى حد ما. أتذكر تلك الأسابيع الأولى كلاجئة في جوما عندما كانت الجثث تتراكم في شوارع المدينة قبل أن تتمكن عائلتي من تنظيم ملجأ أكثر استدامة في كينيا.
الوثائقي: تتتبع فيكتوريا أوونكوندا رحلتها للهروب من الإبادة الجماعية في رواندا منذ 30 عامًا وتلتقي بالضحايا ومرتكبي أعمال العنف لإيجاد طريقة للتصالح والتسامح.
استمع الآن على بي بي سي ساوندز
ولكن بالعودة إلى رواندا، كانت شابة أخرى – كلوديت موكارومانزي البالغة من العمر 13 عامًا – تعيش كابوسًا من الهجمات المتعددة على مدار عدة أيام.
إنها معجزة أنها نجت. تبلغ الآن 43 عامًا، ولديها أحفاد ووافقت على إخباري ببعض تجاربها – إلى جانب أحد المسؤولين عن ندوبها.
وقعت إحدى الاعتداءات التي وصفتها على بعد أمتار قليلة من المكان الذي التقينا فيه في نياماتا، وهي بلدة تقع في جنوب شرق رواندا.
كان هذا في الكنيسة الكاثوليكية حيث لجأ مئات الأشخاص إلى الملجأ، لكن تم مطاردتهم وقتلهم، غالبًا على يد أشخاص يحملون المناجل.
“لقد كان واقفاً داخل الكنيسة عندما جرحني. وكان يغني عندما كان يجرحني. لقد جرحني في وجهي وشعرت بالدم يسيل على وجهي.
“أمرني بالاستلقاء على بطني. ثم طعنني في ظهري برمح. وما زالت تلك الندوب أعاني منها حتى اليوم”.
وبينما كنت أستمع، أذهلتني مدى قربنا من العمر عندما انهار عالمنا.
“لقد طعنه [the spear] بقوة وتركتني أفكر أن الرمح قد وصل إلى الأرض”.
لقد هربت بعد أن تمكنت من الوصول خلفها لإزالة السنبلة العميقة في ظهرها.
وذهلت إلى منزل جارتها، ظنت أنها ستكون آمنة.
لكن المراهق واجه بعد ذلك وجهاً لوجه جان كلود نتامبارا، الذي كان آنذاك ضابط شرطة يبلغ من العمر 26 عاماً.
قال لي السيد نتامبارا: “كانت مختبئة في منزل اتصل بنا صاحبه وقال إن هناك إينينزي”.
ويعني هذا المصطلح “الصرصور” وقد استخدمه المتشددون الهوتو وفي وسائل الإعلام لوصف شعب التوتسي.
“لقد وجدتها جالسة على السرير، وقد أصيبت بالفعل بجروح بالغة ومغطاة بالدماء. أطلقت النار على كتفها لأقضي عليها.
“لقد تلقينا أوامر بعدم إنقاذ أي شخص؛ اعتقدت أنني قتلتها”.
لكن بعد مرور بعض الوقت، هربت من المنزل وتجولت بمفردها حتى التقت بشخص تعرفه وقام بعلاج جروحها.
ومع ذلك، فإن التعافي الكامل كان أصعب بكثير، خاصة وأنها اضطرت على مر السنين لرؤية مهاجميها في الشوارع.
مع هذه الجروح العميقة – المرئية وغير المرئية – كيف يمكن للناس المضي قدمًا؟
وكانت السيدة موكارومانزي والسيد نتامبارا من بين أولئك الذين وجدوا طريقة مثيرة للدهشة.
وبينما كنت أسير نحوهما، فوجئت بهما يضحكان معًا تحت ظل شجرة مورقة. لكن ضحكاتهم كذبت مدى صعوبة العملية.
وعندما سألت ضابط الشرطة السابق عما إذا كان يعرف عدد الأشخاص الذين قتلهم أثناء الإبادة الجماعية، هز رأسه بصمت.
وفي نهاية المطاف، اتُهم الشاب وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات لدوره في المجازر.
وبدلاً من قضاء فترة في السجن، قام بخدمة المجتمع بعد أن أظهر الندم والرغبة في طلب المغفرة.
لقد بحث عن السيدة موكارومانزي. ومع ذلك، لم توافق على مسامحته إلا في المرة السابعة التي طلب فيها ذلك.
وقال: “كان علي أن أواجه أفعالي، وأن أعترف بالدور الذي لعبته، وليس فقط بسبب الأوامر”.
يقول ألكسندروس لوردوس، عالم النفس السريري الذي قام بعمل ميداني في رواندا، إن الأمر يتطلب الشفاء الجماعي لبدء الشفاء الشخصي.
وقال لي: “كان العنف حميمياً للغاية، حيث هاجم الجيران الجيران وهاجم أفراد الأسرة أفراد الأسرة. لذلك هناك شعور بعدم معرفة من يمكن الوثوق به بعد الآن”.
“المرحلة النهائية من الشفاء هي البدء بنسيان هوية الناجي والجاني.”
بالنسبة للسيدة موكارومانزي، كان الأمر يتعلق أكثر باعتبارات عائلتها.
“شعرت وكأنني إذا مت دون أن أسامحه، فإن العبء يمكن أن يقع على أطفالي. إذا مت واستمرت تلك الكراهية، فلن نبني رواندا التي أريدها لأطفالي، بل ستكون رواندا”. انا نشأت فى.
“لا أستطيع أن أنقل ذلك إلى أطفالي.”
وتم إطلاق العديد من مبادرات المصالحة الأخرى. أحدهما هو مشروع يقوده المسيحيون ويجمع الجاني والضحية معًا عن طريق الماشية، والتي لها أهمية كبيرة داخل المجتمع الرواندي.
ومن خلال الاعتناء المشترك ببقرة واحدة – والانخراط في محادثات حول المصالحة والتسامح – فإنهم يبنون مستقبلًا أفضل معًا ويأملون في بناء قطيع في يوم من الأيام.
لقد خطت رواندا خطوات واسعة لتوحيد البلاد التي كانت مقسمة على أسس عرقية – في الواقع، من غير القانوني الحديث عن العرق.
ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى أن الحكومة لا تتقبل سوى القليل من المعارضة، إذ غالباً ما يُتهم المنشقون بإنكار الإبادة الجماعية. ويقولون إن بعض الحريات غير موجودة، الأمر الذي قد يعيق التقدم على المدى الطويل.
ربما لا يزال هناك طريق ما يتعين علينا قطعه للتغلب على الماضي، ولكن هذا ما يحدث بالفعل – كما شهدت في رحلتي.
لقد استغرق الروانديون ثلاثة عقود للوصول إلى هذه النقطة من المصالحة.
لكي أعود أخيراً؛ لكي تعيش السيدة موكارومانزي والسيد نتامبارا معًا مرة أخرى كجيران.
لكي نجد جميعًا مكانًا لصدماتنا الجماعية والفردية – مساحة يمكننا الشفاء منها، بمفردنا ومعًا.
لقد كان الإدراك المذهل بالنسبة لي هو أن رواندا، على الرغم من أنها ستحمل دائمًا قطعة من قلبي، لم تعد تشعر وكأنها موطني.
لكنني تصالحت مع ذلك في هذه الرحلة، مما ساعدني أيضًا على شفاء جراحي وسمح لي بقبول ما فقدته.
فيكتوريا أوونكوندا صحفية ومقدمة برامج بي بي سي نيوزداي على خدمة بي بي سي العالمية.










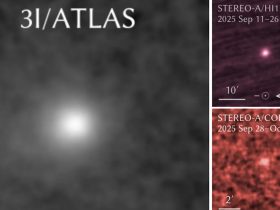









اترك ردك