الأوبئة السابقة التي غالبًا ما يقارن الناس بها كوفيد-19 -جائحة الأنفلونزا عام 1918، والطاعون الدبلي للموت الأسود (1342-1353)، وطاعون جستنيان (541-542)- لا تبدو منذ فترة طويلة لعلماء الآثار. لقد اعتدنا على التفكير في الأشخاص الذين عاشوا منذ عدة قرون أو حتى آلاف السنين. تظهر الأدلة التي تم العثور عليها مباشرة على الهياكل العظمية أن الأمراض المعدية كانت معنا منذ بداياتنا كنوع.
يقوم علماء الآثار الحيوية مثلنا بتحليل الهياكل العظمية للكشف عن المزيد حول كيفية نشوء الأمراض المعدية وانتشارها في العصور القديمة.
كيف سمحت جوانب السلوك الاجتماعي للأشخاص الأوائل بازدهار الأمراض؟ كيف حاول الناس رعاية المرضى؟ كيف قام الأفراد والمجتمعات بأكملها بتعديل سلوكياتهم لحماية أنفسهم والآخرين؟
إن معرفة هذه الأشياء قد تساعد العلماء على فهم سبب تسبب فيروس كورونا (COVID-19) في مثل هذا الدمار العالمي وما يجب القيام به قبل الوباء التالي.
أدلة حول الأمراض منذ فترة طويلة
كيف يمكن لعلماء الآثار الحيوية أن يعرفوا هذه الأشياء، خاصة بالنسبة للثقافات المبكرة التي لم تترك أي سجل مكتوب؟ وحتى في المجتمعات المتعلمة، نادرًا ما تتم الكتابة عن الشرائح الفقيرة والمهمشة.
في معظم المواقع الأثرية، كل ما تبقى من أسلافنا هو الهيكل العظمي.
بالنسبة لبعض الأمراض المعدية، مثل الزهري والسل والجذام، يمكن أن يكون موقع وخصائص وتوزيع العلامات على عظام الهيكل العظمي بمثابة مؤشرات “مرضية” مميزة للعدوى.
ومع ذلك، فإن معظم العلامات الهيكلية للمرض غير محددة، مما يعني أن علماء الآثار الحيوية اليوم يمكنهم معرفة ما إذا كان الفرد مريضًا، ولكن ليس من أي مرض. بعض الأمراض لا تؤثر أبدًا على الهيكل العظمي على الإطلاق، بما في ذلك الطاعون والالتهابات الفيروسية مثل فيروس نقص المناعة البشرية وكوفيد-19. والأمراض التي تقتل بسرعة ليس لديها الوقت الكافي لترك أثر على عظام الضحايا.
للكشف عن أدلة على أمراض معينة تتجاوز التغيرات الواضحة في العظام، يستخدم علماء الآثار الحيوية مجموعة متنوعة من الأساليب، غالبًا بمساعدة متخصصين آخرين، مثل علماء الوراثة أو علماء الطفيليات. على سبيل المثال، تحليل التربة التي تم جمعها في القبر من حول حوض الشخص يمكن أن يكشف عن بقايا الطفيليات المعوية، مثل الديدان الشريطية والديدان المستديرة. يمكن للتحليلات الجينية أيضًا تحديد الحمض النووي لمسببات الأمراض المعدية التي لا تزال ملتصقة بالعظام والأسنان القديمة.
يمكن لعلماء الآثار الحيوية أيضًا تقدير العمر عند الوفاة بناءً على مدى تطور أسنان وعظام الطفل، أو مقدار تدهور الهيكل العظمي لشخص بالغ على مدار حياته. ثم يساعدنا علماء السكان في رسم ملامح عمرية للسكان الذين ماتوا في الأوبئة. تؤثر معظم الأمراض المعدية بشكل غير متناسب على الأشخاص الذين لديهم أضعف أجهزة المناعة، وعادة ما يكونون صغارًا وكبارًا جدًا.
على سبيل المثال، كان الموت الأسود عشوائيًا؛ تحتوي حفر الدفن التي تعود إلى القرن الرابع عشر على التوزيعات العمرية النموذجية الموجودة في المقابر التي نعلم أنها لم تكن مخصصة لضحايا الموت الأسود. في المقابل، كان جائحة الأنفلونزا عام 1918 غير عادي لأنه أصاب بشدة أولئك الذين يتمتعون بأقوى أجهزة المناعة، أي الشباب الأصحاء. ويترك فيروس كوفيد-19 اليوم أيضًا ملفًا تعريفيًا مميزًا للأشخاص الأكثر عرضة للوفاة بسبب المرض، ويستهدف كبار السن والضعفاء ومجموعات عرقية معينة.
يمكننا معرفة أنواع العدوى التي كانت موجودة في الماضي من خلال بقايا أسلافنا، ولكن ماذا يخبرنا هذا عن الصورة الأكبر لأصل العدوى وتطورها؟ يمكن للقرائن الأثرية أن تساعد الباحثين على إعادة بناء جوانب التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والبيئة والتكنولوجيا. ويمكننا دراسة كيف تسببت الاختلافات في عوامل الخطر هذه في اختلاف الأمراض عبر الزمن، وفي مناطق مختلفة من العالم، وحتى بين الأشخاص الذين يعيشون في نفس المجتمعات.
كيف حصلت الأمراض المعدية على موطئ قدمها الأول
تؤثر البيولوجيا البشرية على الثقافة بطرق معقدة. وتؤثر الثقافة على علم الأحياء أيضًا، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب على أجسادنا مواكبة التغيرات الثقافية السريعة. على سبيل المثال، في القرن العشرين، حلت الوجبات السريعة عالية المعالجة محل النظام الغذائي الأكثر توازنًا وصحة بالنسبة للكثيرين. ولأن جسم الإنسان تطور وصمم لعالم مختلف، فقد أدى هذا التحول الغذائي إلى ارتفاع أمراض مثل السكري وأمراض القلب والسمنة.
من وجهة نظر علم الأوبئة القديمة، كان الحدث الأكثر أهمية في تاريخ جنسنا البشري هو اعتماد الزراعة. نشأت الزراعة بشكل مستقل في عدة أماكن حول العالم منذ حوالي 12000 سنة.
قبل هذا التغيير، كان الناس يعيشون على الصيد وجمع الثمار، وكانت الكلاب هي رفاقهم الوحيدين من الحيوانات. لقد كانوا نشيطين للغاية وكان لديهم نظام غذائي متوازن ومتنوع غني بالبروتين والألياف ومنخفض السعرات الحرارية والدهون. عانت هذه المجموعات الصغيرة من الطفيليات والالتهابات البكتيرية والإصابات أثناء صيد الحيوانات البرية وفي بعض الأحيان القتال مع بعضها البعض. كان عليهم أيضًا التعامل مع مشاكل الأسنان، بما في ذلك التآكل الشديد والترسبات وأمراض اللثة.
ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي لم يكن على الصيادين وجامعي الثمار القلق بشأنه كثيرًا هو الأمراض المعدية الفتاكة التي يمكن أن تنتقل بسرعة من شخص لآخر في جميع أنحاء منطقة جغرافية كبيرة. لم تكن مسببات الأمراض مثل فيروس الأنفلونزا قادرة على الانتشار بشكل فعال أو حتى الحفاظ عليها من قبل مجموعات سكانية صغيرة ومتنقلة ومعزولة اجتماعيًا.
أدى ظهور الزراعة إلى زيادة عدد السكان المستقرين الذين يعيشون على مقربة من بعضهم البعض. ويمكن أن تزدهر أمراض جديدة في هذه البيئة الجديدة. اتسم التحول إلى الزراعة بارتفاع معدل وفيات الأطفال، حيث توفي حوالي 30% أو أكثر من الأطفال قبل سن الخامسة.
ولأول مرة في التاريخ التطوري الممتد لملايين السنين، أصبحت الأنواع المختلفة من الثدييات والطيور متجاورة حميمة. بمجرد أن بدأ الناس في العيش مع الحيوانات المستأنسة حديثًا، تم إدخالهم إلى دورة حياة مجموعة جديدة من الأمراض – تسمى الأمراض الحيوانية المنشأ – والتي كانت في السابق مقتصرة على الحيوانات البرية ولكن يمكنها الآن الانتقال إلى البشر.
أضف إلى كل هذا ضغوط سوء الصرف الصحي ونقص النظام الغذائي، فضلاً عن زيادة الاتصالات بين المجتمعات البعيدة من خلال الهجرة والتجارة وخاصة بين المجتمعات الحضرية، وتمكنت أوبئة الأمراض المعدية من الانتشار لأول مرة.
عولمة المرض
أدت الأحداث اللاحقة في تاريخ البشرية أيضًا إلى تحولات وبائية كبيرة تتعلق بالمرض.
على مدار أكثر من 10000 عام، تطورت شعوب أوروبا والشرق الأوسط وآسيا جنبًا إلى جنب مع أمراض حيوانية معينة في بيئاتهم المحلية. تختلف الحيوانات التي كان الناس على اتصال بها من مكان إلى آخر. وبما أن الناس عاشوا جنبا إلى جنب مع أنواع حيوانية معينة على مدى فترات طويلة من الزمن، فمن الممكن أن يتطور التعايش ــ فضلا عن المقاومة المناعية للأمراض الحيوانية المنشأ المحلية.
وفي بداية التاريخ الحديث، بدأ أيضًا أشخاص من الإمبراطوريات الأوروبية بالسفر حول العالم، حاملين معهم مجموعة من أمراض “العالم القديم” التي كانت مدمرة للمجموعات التي لم تتطور جنبًا إلى جنب معهم. لم يكن لدى السكان الأصليين في أستراليا والمحيط الهادئ والأمريكتين أي معرفة بيولوجية بمسببات الأمراض الجديدة. ومن دون مناعة، اجتاح وباء تلو الآخر هذه المجموعات. تتراوح تقديرات الوفيات بين 60-90٪.
لعبت دراسة الأمراض في الهياكل العظمية والمومياوات وغيرها من بقايا الأشخاص السابقين دورًا حاسمًا في إعادة بناء أصل الأوبئة وتطورها، لكن هذا العمل يقدم أيضًا دليلاً على التعاطف والرعاية، بما في ذلك التدخلات الطبية مثل نقب العظام، وطب الأسنان، وبتر الأطراف، وجراحة العظام. الأطراف الاصطناعية والعلاجات العشبية والأدوات الجراحية.
وتظهر أدلة أخرى أن الناس غالبا ما يبذلون قصارى جهدهم لحماية الآخرين، وكذلك أنفسهم، من المرض. ولعل أحد الأمثلة الأكثر شهرة هو قرية إيام الإنجليزية، التي اتخذت قرارا بالتضحية بعزل نفسها لمنع انتشار الطاعون من لندن في عام 1665.
في عصور أخرى، تم وضع الأشخاص المصابين بالسل في المصحات، وتم إدخال الأشخاص المصابين بالجذام إلى المستشفيات المتخصصة أو عزلهم في الجزر أو المناطق النائية، وفر سكان المدن من المدن عندما جاء الطاعون.
إن السجل الأثري والتاريخي يذكرنا بأن الناس عاشوا مع الأمراض المعدية لآلاف السنين. وقد ساعدت مسببات الأمراض في تشكيل الحضارة، وكان البشر صامدين في مواجهة مثل هذه الأزمات.
تم إعادة نشر هذا المقال من The Conversation، وهي منظمة إخبارية مستقلة غير ربحية تقدم لك حقائق وتحليلات جديرة بالثقة لمساعدتك على فهم عالمنا المعقد. كتب بواسطة: شارلوت روبرتس، جامعة دورهام; غابرييل د.روبيل, جامعة ولاية ميشيغان، ومايكل ويستواي، جامعة كوينزلاند
اقرأ أكثر:
يتلقى مايكل ويستواي تمويلًا من مجلس البحوث الأسترالي.
شارلوت روبرتس وغابرييل د. لا يعمل روبيل في أي شركة أو مؤسسة أو يستشيرونها أو يمتلكون أسهمًا فيها أو يتلقون تمويلًا منها قد تستفيد من هذه المقالة، ولم يكشفوا عن أي انتماءات ذات صلة بعد تعيينهم الأكاديمي.













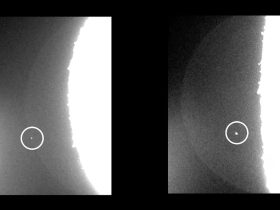



اترك ردك